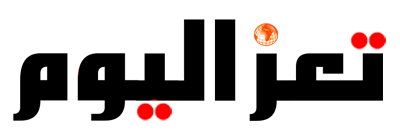أسفار أيوب..شــلال ضــوء وترانيــم محبــة (الحلقة الثالثة)
مثلما تورق الكروم وتزهر في الروابي؛ تورق أغنياته فينا وتخضر حباً، وتزهر عشقاً.
ومثلما تتبرعم عناقيدها في قلوب محبيه وتثمر، تتعنقد فينا إبداعاته الفنية أشواقاً ومحبة.
حنيناً ولقاءً..
أنيناً وصفاءً..
ترانيم وجد، وألحاناً آسرة.
تغسل الأرواح، وتنقي القلوب، وتشفي أوجاعها.
تشجي النفوس الحائرة، وتطهر أحزانها.
منوعات – تعز اليوم :
مع كل نغمة حب، هفت أرواحنا، سفراً ورحيلاً، وفي كل ترنيمة شجن، هامت قلوبنا فرحاً وحزناً، تحملها تقاسيم لحونه الماطرة، نحو مدارب فيوضها، حين يشدو بجمال الكلمة وعذوبتها، ويزيدها عذب صوته الآسر رقة وانسياباً، وتمنحها رخامته رونقاً وبهاءً، ليسافر بنا نحو فضاءات الكلمة وعوالم رحابه، وصلاً وانكساراً، بوحاً وجرحاً، بلسماً وهياماً، تباريح عشق، وتسابيح محبة..!
في منتصف الستينيات، وقبل أن ينهي الشاب أيوب دراسته الثانوية في معهد البيحاني، سنحت له الفرصة للعمل في شركة (B.T.C) بواتينج ترايدنج كامبني الصينية الخاصة ببيع الملابس الشتوية، التي كان يديرها أحد التجار في مدينة عدن، وكان معظم زبائنها من الإنجليز، وكان مقرها في إحدى العمارات في شارع المعلا الخلفي، وقد خصص صاحبها الدور الرابع منها سكناً لموظفيها، بالإضافة إلى ديوان (مقيل) يجتمعون فيه مع أصدقائهم لمضغ (القات).
(تقدمت للامتحان مع عدد من الشباب من مختلف المناطق اليمنية، وحصدت أفضل الدرجات من بينهم، وكان ترتيبي الأول عليهم، وحصلت على الوظيفة كمحاسب. فاستقر بي المقام في هذه الوظيفة).
في هذه الشركة يواصل الشاب أيوب أسفاره في عدن التي نواصل تعقبها معه في هذا الحوار، ونستشرف أبرز محطاته فيها محطة محطة، وننبش معه تفاصيل ذكرياتها حلوة كانت أو مرة، بقياسات عذاباتها في ذاك الزمان.
ومثلما كان الشاب أيوب بملكته الإبداعية التي منحه إياها الخالق، يجيد ترتيل القرآن بصوته العذب، أجاد في سفره الجديد الأرقام والعمليات الحسابية، وخلال فترة قصيرة من عمله في الشركة، رقِّي من موظف أمين مخازن الشركة إلى إدارة حساباتها، ومن مرتب 250 شلناً إلى مرتب أعلى منه.
فظن الشاب أيوب أن الحياة مرة أخرى تمنحه ابتسامتها في هذه المدينة الجميلة التي منحته العلم والمعرفة، وأحبها وعشقها وسكنه عشقها قبل أن يسكنها، ومازالت حتى اللحظة بجمال أمكنتها وذكريات أزمنتها تسكن حنايا روحه، وتعيش بكل تفاصيلها في تلافيف ذاكرته وفي أعماق وجدانه.
إلا أنها أيضاً هي المدينة نفسها التي كانت شاهدة على لحظات انكساراته في بادئة أسفاره الجديدة نحو حياة ببراءة ظن أنها دوماً تمنحه ابتسامتها.
فعلى سطوح منازلها طافت روحه وهامت، وناجت نجوم سماها والقمر، وبكت شعراً انكسار قلبه على حب عاثر:
هكذا فاضت روح الشاب أيوب بلواعج أحزانها شعراً في إحدى ليالي عدن الجميلة، ووحدها عدن قاسمته حزنه وانكسارات روحه حينما علم بزفاف من أحبها منذ أن كانا صغيرين يرعيان الغنم في قريته النائية، وتعلق بها قلبه صبياً أثناء ما كان يعود إليها في عطلاته الدراسية، وهي النفحة الشعرية الوحيدة التي تنفسها حينها ولم يكتب غيرها طيلة عمره، وكتم سر جواها في صدره، ولم يفكر يوماً في تلحينها أو التغني بها، وظل محتفظاً بها في ذاكرته بكامل أبياتها، وبين جوانحه فقط كذكرى أثيرة تكفلت الأيام بتجاوز وجع لحظتها، ووفت أسفار السنين بنسيان آلامها.
أيوب الفتى الذي جاء إلى هذه المدينة وشب فيها ونهل من معارفها، قرأ كل ما كان يقع بين يديه من المطبوعات التي كانت تصدر في عدن حينذاك، وما يوزع فيها من صحف ومجلات عربية ومن الكتب الثقافية والأدبية والشعرية وكتب السير التاريخية كسيرة عنترة بن شداد وغيرها من إصدارات تلك الفترة.
(كنت أقرأ كل ما يقع بين يدي، ومن ضمن الكتب التي قرأتها كان كتاب (وا إسلاماه) لباكثير، وتأثرت به كثيراً، ولكن حينما شاهدته فيلماً في السينما، ندمت أكثر، كون ما قرأته شيئاً وما يجسده الفيلم عن هذه القصة الرائعة شيئاً آخر ومغايراً لما كنت قد قرأته في الكتاب).
ذلك سفر من أسفار الفتى أيوب في عدن، ولكن حكايات وأسفار الشاب أيوب مع هذه المدينة، لم تنتهِ بعد، وله مع كل حارة وشارع فيها سفر وحكاية، وفي كل زاوية من زواياها قصة وموقف وذكرى جديرة بأن تروى، وجدير بنا أن نتتبعها ونستعيدها معه بكل تفاصيلها.. في الفترة التي عاشها أيوب طالباً في عدن من نهاية الخمسينيات وحتى نهاية ستينيات القرن الماضي، كانت عدن تزهو بمختلف أنواع الثقافة والفنون ووسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة، ومنها إذاعة عدن التي كانت في ذلك الوقت نافذة ثقافية وفنية لمختلف الشرائح الاجتماعية في الريف والمدينة، خصوصاً بعد أن أصبحت أجهزة الترانزستور (الراديو) في متناول الكثير من شرائح المجتمع.
(استمرت علاقتي بالإذاعة كمتابع لبرامجها الثقافية والفنية، إلا أن أكثر ما كان يشدني من برامجها الفنية، الفقرة المخصصة لأغاني الموسيقار محمد عبدالوهاب، التي كانت تبثها الإذاعة مساء كل يوم من الساعة الـ9 الى الـ10 والنصف.. ومن أطرف ما أتذكره في هذه الفترة أنه كان لي صديق معجب بالفنان فريد الأطرش، ويفضله على الموسيقار عبدالوهاب، وكانت تحدث بيننا مشاكسات بسبب هذا الإعجاب وهذا التفضيل، إلى درجة أنه ذات يوم تحداني بأن يرسل كل منا برسالة إلى فنانه المفضل، ويطلب فيها منه صورته الشخصية. قبلت التحدي معه، وأرسل كل منا برسالته، وبقينا ننتظر ردهما لنا، وبعد فترة لبى الموسيقار فريد طلب صديقي، وبقيت أنا أنتظر رد فناني المفضل دون جدوى، مما زاد من مشاكسة صديقي لي كون (صاحبي عبد الوهاب) لم يرد على رسالتي. إلا أن عدم رده هذا وتزايد مشاكسات صديقي التي كان يحاول من خلالها إغاظتي أو أن يكرهني بفناني المفضل، لم تؤثر عليَّ أو تقلل من حبي للفنان عبد الوهاب، وبقيت معجباً به ووفياً لصوته).
لقد سمع أيوب أثناء سنوات أسفاره في عدن طالباً وموظفاً فتى يافعاً وشاباً عاشقاً ومحباً، أصواتاً فنية جميلة ومتعددة، في وقت كانت فيه مستعمرة عدن وما جاورها من سلطنات الجنوب – كما كانت تسمى قبل الاستقلال ـ حاضنة للفن والطرب الجميل، وتعج وتزخر بقاماته الإبداعية على اختلاف مدارسهم الفنية وألوانهم الغنائية؛ إلا أن أيوب ظل على مسافة قريبة من روحه، وحافظ على نقاء فطرته الإنسانية الأولى تجاه كل ذلك.
(كنت أسمع كل ما كان يلامس وجداني، لكني لم أتأثر بأي أحد من فناني تلك الفترة، عدا محمد عبدالوهاب الذي كنت معجباً به حد الجنون كما ذكرت لك سابقاً، وهذا لايعني خلو الساحة الفنية آنذاك من الأصوات الجميلة، بل على العكس فقد احتضنت عدن الكثير من العائلات الفنية والأصوات النادرة التي هاجرت إليها من مختلف المدن والمناطق اليمنية، حاملة معها ما كانت تزخر به الذاكرة الشعبية من فنون غنائية وتراث شعبي متوارث، حفظته هذه العائلات وتناقلته أجيالها الفنية المتعاقبة، واستطاعت بعض أصواتها الغنائية بحسب إمكانياتها المتاحة بمقدار ما هيأته لها عدن حينذاك، أن تحافظ على جزء بسيط من هذا التراث وهذا الموروث الشعبي الجميل الذي هو في مجمله يشكل تراثنا الفني اليمني الأصيل، والذي تزخر به مختلف المناطق اليمنية، وللأسف اندثر معظمه، ويكاد يندثر ما تبقى منه دون أية التفاتة من القنوات الرسمية للحفاظ عليه وتوثيقه بشكل مؤسسي وبطرق علمية، فكل ما وثق منه حتى الآن هو شيء يسير، وبجهود فردية وإحساس ذاتي لتلك الأصوات التي قامت به أمثال الماس والقعطبي وباشراحيل ومحمد جمعة خان وغيرهم.. بما في ذلك الأصوات الشعبية المغمورة التي كانت تعيش على هامش الحياة، ولكنها كانت تحفظ الكثير من إيقاعات التراث الشعبي والألحان الغنائية الجميلة أمثال نعائم بنت شريان، وهي صاحبة صوت مجوهر، وقد تعرفت على صوتها الجميل من خلال أدائها لبعض الأغاني القديمة التي كانت قد سجلتها لها بعض استيريوهات عدن بمصاحبة الناي فقط أو العود أحياناً، وحصلت على بعضها، وأعجبت جداً بصوتها وبطريقة أدائها لتلك الأغاني القديمة كأغنية (في الليل أشكو للنجوم حالي) و(ظالم شغل بالي) التي غناها في ما بعد الفنان أحمد السنيدار).
بين طموح أيوب بمواصلة دراسته الجامعية التي حال دونها توقف الدراسة في معهد البيحاني قبيل الامتحانات النهائية في العام 63م، ثم إغلاقه بسبب المظاهرات وإعلان الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب، وفرصة الوظيفة التي حصل عليها أثناء ذلك، والتي أخذت تدر عليه دخلاً جيداً بقياس تلك الفترة؛ بدأ الشاب أيوب يفكر جدياً في استغلال ذلك المردود المادي كمدخل في تحقيق طموحاته، بما في ذلك طموح إكمال دراسته ومتابعة التحصيل العلمي العالي، إلا أنه في نفس العام أيضاً، وهما في إجازة في القرية، عرض عليه والده الزواج من إحدى فتياتها، فما كان بوسع الشاب أيوب أن يرفض هذا العرض شبه الإجباري لوالد عرف عنه الصرامة بطيبة قلب وخشونة يد، فقبل به أو رضخ له مستسلماً لأوامره.. وبعد انتهاء (شهر العسل) وإجازته السنوية في القرية، عاد الشاب أيوب إلى عدن برفقة شريكة حياته لمواصلة عمله، على أمل أن يؤدي امتحانات إكمال شهادة الثانوية العامة في حال انتهت الإضرابات وعاود المعهد فتح أبوابه. إلا أن الظروف السياسية الجديدة التي شهدتها عدن آنذاك منذ العام 63م عام انطلاق ثورة 14 أكتوبر التحريرية في الجنوب اليمني، واشتداد المظاهرات الطلابية والإضرابات العمالية؛ حالت دون تحقيق ذلك الأمل، ومن جهة أخرى كان لتغير الظروف على صعيد حياته الشخصية ومسؤولياته الجديدة كرب أسرة، وإصرار والده عليه وإقناعه بالتمسك بفرصة العمل كونه لم يعد بمقدوره أن يتحمل تكاليف وأعباء حياة ابنه الشاب الجديدة بعد زواجه، بل وبصريح العبارة صارح الأب ابنه أنه لم يعد بإمكانه الاعتماد عليه بعد الآن كما كان في السابق، وعليه أن يتحمل مسؤولياته بنفسه. لذلك عمل الشاب بنصيحة والده، وكان عليه أن يشق طريق حياته ومستقبله معتمداً على نفسه كشاب ناضج يعي حجم مسؤولياته، ليس فقط تجاه أسرته الصغيرة حديثة التكوين، بل تجاه عائلته الكبيرة كلها التي يتحمل والده رعايتها، وإن واجب مساعدته في ذلك حق عليه.. انغمس الشاب أيوب بين مسؤوليات الوظيفة وأسرته الناشئة، وبين حلم إكمال الدراسة.
وفي مساء ذات يوم، وبينما هو يسير في شارع المعلا الرئيسي برفقة (صهره) – الذي كان هو الآخر يعمل في عدن لدى أحد الإخوة اللبنانيين، ووفر له سكناً جميلاً في نفس الشارع ـ توقف فجأة بعد أن رأى (عوداً) كان معلقاً في أحد المحلات الخاصة ببيع مواد وأدوات (السباكة)، وكان أمر وجود هذه الآلة الموسيقية (العود) بين تلك الأدوات المستخدمة (حراج الخردة)، أمراً غريباً وناشزاً؛ وكأنه كان يستنجد بهذا المار الغريب أو (يستغيث) ـ كما هو تعليق أيوب نفسه – ويقول له خذني معك، فهذا المكان ليس مكاني، ووجودي فيه لايليق بي، ومن هذا المساء أنا رفيقك وأنا كل مستقبلك وكل حياتك الآتية.
وبعد مفاصلة مع صاحب المحل طلب 150 شلناً كسعر نهائي لذلك (العود)، دفع أيوب 50 شلناً وصهره 50، وهو كل ما كان بحوزتهما من المال، واتفقوا على أن يترك أيوب (خاتم زواجه) ببقية المبلغ (كرهن) يبقى لدى صاحب المحل ومشروطاً بفترة محددة لاتتعدى شهراً واحداً.
عاد أيوب في ذلك المساء فرحاً إلى مقر سكنه في نفس الشركة، وصعد السلالم متسللاً هو و(عوده) نحو السطوح خوفاً من أن يراه أي أحد ويشي به عند والده.
كل مساء كان يصعد وعوده الى السطوح، وبتلقائية روحه المرحة يبدأ بالعزف عليه عشوائياً، فتضبط معه حيناً نغمة جميلة هنا، ويضج السطح في أغلب الأحيان بأصوات أكثر نشازاً مصدرها خبطة متشنجة بطريقة توحي بملل صاحبها ونفاد صبره على ريشة بين الأنامل لم تهتدِ بعد سبل أوتارها، بالرغم من أن الأنامل التي تمسك بها هي نفس الأنامل التي قد اعتادت أن تعزف على شبابتها أحلى الأنغام في تلك القرى النائية.
وتتكرر العملية في ما يشبه العناد كل مساء، وسط مساندة زملائه وأصدقائه وتشجيعهم له بإعادة المحاولات وتكرارها.
إلاّ أن ذلك لم يدم طويلاً، فخبر شراء العود ومحاولات تعلم أيوب بنفسه العزف عليه – رغم سريته، وبالرغم من أنه لم يمضِ عليه سوى عدة أسابيع – انتشر بين الأهل والمقربين، وبطريقة أو بأخرى تناهى إلى مسامع والده، وفي مساء أحد الأيام لم يدرِ أيوب إلا ووالده قد جاء إليه وهو في حالة هيجان وغضب بسبب ذلك، ولولا تدخل الأصدقاء وزملائه في السكن وقيامهم بتهدئة الأب وتبريرهم له بأن العود ليس لأيوب، وإنما يعود (لصهره)، لكان قد حدث ما لايحمد أيوب عقباه، ومع ذلك لم يشفِ غليل الأب إلا تلك الصفعة القوية التي عاقب بها ابنه بعد أن انفرد به بعيداً عن أعين رفاقه، وموبخاً ومهدداً له بألا يعود لهذا الأمر، فاستغل (صهر) أيوب هذه الحادثة، فأخذ (العود) معه وذهب إلى حي (كريتر)، ولم يعد به.
وبعد مرور عدة أسابيع على هذه الحادثة، التقاه أيوب وسأله عن مصير (العود)، وحينما طلب استعادته منه، اعترف له أنه احتاج للمال فباعه.
ليلتها عاد أيوب إلى السكن شارد الذهن ومشغول البال، ليس لأنه خسر (العود) وقيمته وخسر (خاتم زواجه) فقط، بل لأن (موضوع الفن) وتعلم العزف على (العود) ـ بالرغم من اعتراضات والده على ذلك ـ قد أصبح جدياً بالنسبة له، وشاغلاً لكل تفكيره.
وفجأة تذكر الفنان (حمود عطيري) الذي كان قد تعرف عليه في المعلا، وكان معجباً بنقاء صوته، وببعض أغانيه التي كان يؤديها مثل أغنية (حبيبي تعال) وأغنية (خدعوها بقولهم حسناء)، التي غناها أيوب في ما بعد، أو (لطشها)، بحسب تعبيره.
استمر أيوب في الخفاء في ممارسة هوايته الجديدة التي قادته نحوها مشاعر وأحاسيس لم يدرك هو نفسه كنهها، بل لم تخطر على باله أو فكر فيها مجرد التفكير، بالرغم من أن الجميع من حوله كان يدرك أنه يمتلك بالفطرة كل مقوماتها، بل أهم ملكاتها الإبداعية المتمثلة في رخامة صوته العذب ونقاوته.
(كنت أذهب إلى عند الفنان (عطيري) كل ليلة تقريباً، ورغم أنه كان قد وعدني بأن يعلمني طريقة العزف على آلة العود، إلا أنه لم يكن جاداً معي في ذلك، وكان المال الذي يأخذه مني كل ليلة مقابل كل جلسة، هو الأهم بالنسبة له، لذلك لم أستمر معه طويلاً، لأني كنت مركزاً على نغمات موسيقية محددة كانت موجودة في ذهني مسبقاً لبعض الأغاني كأغنية (يا رب لاطف عبدك الحائر) وغيرها من الأغاني التي كان يؤديها كبار الفنانين أمثال القعطبي.
لكن من شجعني وساعدني أكثر في هذا المجال، هم زملائي وأصدقائي، ومعظمهم من أهل قريتي ممن يعرفهم أبي رحمه الله، والذين استطاعوا أن يقنعوه بأن الفن ليس عيباً ولا حراماً، وبصعوبة اقتنع بواسطتهم، فسمح لي بأن أتعلم العزف على العود، ولكن بشروطه هو التي كان من أهمها ألا أترك عملي، وأن أتعلم العزف كهواية وليس كمهنة، ويكون العود الذي أهداني إياه صديقي عبدالكريم عبدالله ناشر دائماً في منزله هو، وليس في أي مكان آخر، حتى لا أغيب عن عينه هنا أو هناك.
وكان من بين هؤلاء الأصدقاء الذين ساندوني وشجعوني بعض الفنانين الهواة من قريتي ممن سبق لهم الغناء والتلحين، ولكن بسبب ظروف معينة ربما تكون خاصة بمحيطهم أو بهم، لم يوفقوا في الاستمرار، مثل الفنان محمد أحمد بشر، وهو صاحب ذائقة فنية جميلة، ومن لحن أغنية (قلبي الجريح) التي كتب كلماتها الشاعر صالح اللبن، الذي كنا قد التقينا به أمام سينما عدن، وسلمه هذه القصيدة ليغنيها هو، إلا أن الفنان بشر بعد أن قام بتلحينها عاد وقدمها لي في ما بعد، بالإضافة إلى أغانٍ غيرها مثل (يا قبوة الكاذي) و(أهلاً بمن حبي تكلم)، ولكنها كلها لم ترَ النور، فقدمها بعد ذلك لفنان آخر من أصدقائه كان يتعامل مع تسجيلات (القرشي)، في الشيخ عثمان، بعد أن فشلت محاولاته معي وعروضه المتكررة لإقناعي بتسجيلها لدى تسجيلات القرشي الذي كان صديقه، ويريد أن يسحبني إليه عبر تلك الأغاني، فاعتذرت لصديقي (بشر) عن عدم قدرتي القيام بذلك، لأنني كنت حينها قد اتفقت بعقد عمل رسمي مع (أحمد الدبعي) صاحب تسجيلات (صوت الوحدة).