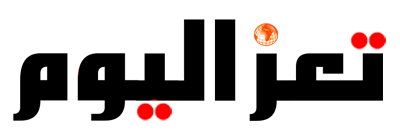كانت الرياض راغبة في استقرار سريع للأوضاع في اليمن لما يمثله استمرار الاضطراب من إزعاج ومخاوف على أمنها وحدودها، وكذا خشية استغلال التنظيمات الإرهابية للفراغ الأمني والعسكري في مناطق انتشارها، وشاركتها واشنطن نفس المخاوف والقلق، في حين كان الرئيس السابق ما زال وأسرته يعيشون تحت تأثير محاولة خصومه قتله في مسجد دار الرئاسة، وكذا شعورهم بأن السلطة الحقيقية آلت إلى معارضيه وخصومه ومن دبروا مؤامرة اغتياله مع عدد من كبار رجالات الدولة.
لم يكن تطور الخلاف بين الرئيسين هادي وصالح في جوهره حول إدارة الدولة ومؤسساتها، وإنما ارتبط بتاريخ طبيعة العلاقة الشخصية بينهما، وشعور هادي بأن الفرصة صارت مواتية لينتقم من بقائه في ظل صالح وأبنائه طيلة ثمانية عشر عاماً لم يمارس خلالها أي نشاط ذي قيمة، عدا رئاسة اللجنة العليا للاحتفالات الوطنية، وفي واقع الحال الممارس فإن نائب الرئيس في أي دولة لا يقوم بأي مهام غير ما يكلفه بها رئيس الدولة، ومن المؤكد أن هذا جعل النائب حينها يشعر بعدم أهميته داخل هيكل رئاسة الجمهورية، خصوصاً في وجود شخصية قوية طاغية ممسكة بكل تفاصيل الحكم.
الرئيس السابق اختار هادي نائباً له من بين العديد من القيادات التاريخية الجنوبية المعروفة، وكان يعلم أنه لن يتمكن من الخروج إلى الناس والانفتاح على مكونات اليمن الاجتماعية خصوصاً القبلية التي كان يعيش في محيطها، لأن شكوك هادي تجاههم كانت حقيقية وقوية ومزمنة، وحين صار رئيساً كان، إلى جانب الدعم الخارجي، يعتمد على اللواء علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح بصورة أساسية، ولم يتمكن من تجاوز دائرته الضيقة التي عاش فيها طيلة سنوات عمله مع صالح، ولم يكن حتماً يثق بالتكوينات العليا في المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه أساساً، وذاك أمر طبيعي لأنه يعلم يقيناً أنهم يدينون بالولاء التام لسلفه وممن اختارهم لمساعدته في إدارة الدولة والتنظيم.
ظل الرئيس هادي يمارس سلطاته معتمداً في الأساس على الدعمين الإقليمي والدولي، خصوصاً من السعودية والولايات المتحدة، وكذلك رغبة معارضي صالح في التخلص من النظام السابق ومن كانوا يطلقون عليهم “الفلول”، وتصفية ما أطلقوا عليه “الجيش العائلي”، ولم يبذل الجهد المضاعف المطلوب للتواصل، ولم يبدِ الحيوية المطلوبة من قائد في مرحلة أثرت في تاريخ اليمن وأدت تبعاتها إلى ما يمر به اليمن حالياً وستبقى آثارها تنسحب لعقود مقبلة.
وبدأت أعمال مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس (أذار) 2013، وغادر بعدها الرئيس الراحل في مطلع أبريل (نيسان) لإجراء فحوصات طبية في الرياض التي أرسلت إليه طائرة خاصة لنقله مع مرافقيه، واستضافته السعودية في “قصر المؤتمرات”، حيث بقي هناك لأكثر من أسبوعين، لكن سيطرة الهواجس والشكوك استمرت تلقي ظلالها على علاقاتهما، وتعثرت مساع بدَّلها على وجه الخصوص الدكتور الإرياني الذي كان محل ثقة الرجلين لإزالتها أو حتى التخفيف منها! ثم بدأت محاولات كثيرة لإقناع صالح بالخروج للعلاج والاستقرار في الخارج، وإن كان قد أبدى استعداده فإنما كان ذلك من باب معرفة ما إن كان سيُمنح تأشيرات دخول إلى العواصم الأوروبية، كما قال لي في آخر لقاء بيننا في منزله بصنعاء منتصف يونيو (حزيران) 2013.
سار مؤتمر الحوار الوطني بشكل مثير للإعجاب من حيث القضايا التي طرحت للنقاش وتنظيمه وحماس المشاركين، خصوصاً النساء والشباب، ولم يعكر مساره سوى حادثة محزنة أدت إلى مقتل الشابين خالد الخطيب وحسن آمان، في منتصف مايو (أيار) 2013 على يد مرافقي أحد أعضاء مؤتمر الحوار من ممثلي حزب الإصلاح، وكان ذلك اختبارا لقدرة الرئيس هادي في التعامل مع مثل هذه القضايا الجنائية، لكنه لجأ إلى نفس أسلوب سلفه في معالجة مثل هذه القضايا التي يتهم بارتكابها رجال القبائل، إذ كان صالح يتجنب الدخول معهم في صراعات، خشية امتدادها إلى مناطق لا يستطيع التحكم فيها، واكتفى المحتجون بشعار “لن يمروا” وتجمعات صغيرة أمام منزل الرئيس ومقر مؤتمر الحوار، وبمرور الأيام نسى الناس الأمر إلا أسرة القتيلين، ومر القتلة كما مر غيرهم من قبل.
في يناير (كانون الأول) 2014 أعلن الرئيس انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني بعد عشرة أشهر من النقاشات داخل جدران فندق الموفينبيك، وكان واضحاً أن المرحلة الانتقالية ستمتد إلى فترة أطول مما كان منصوصا عليه في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية “المزمنة”، إذ أدخل ترزية القوانين والمستشارون تفسيراً للزمن ابتكره جمال بنعمر، وقالوا إنه لا يعني الوقت بل التنفيذ! ثم كان التوقيع على وثيقة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم بطريقة ظهرت على الشاشات كما لو كانت قسرية، ورفض ممثلو جماعة أنصار الله (الحوثيون) التوقيع عليها، ورفضها المؤتمر الشعبي العام رغم توقيع الدكتور الإرياني نيابة عن التنظيم، واعترض عليها أغلب ممثلي الحراك الجنوبي، رغم أن ياسين مكاوي وضع اسمه لأسباب لا علاقة لها بموافقته رغم عدم قناعته.
وكانت وثيقة تقسيم الأقاليم في نظري مبينة على رغبات سياسية أكثر منها دراسات علمية، فرغم كل ما قيل عن معايير فنية رُوعيت فلا شيء في حدود الأقاليم يبرهن هذه الفرضية، ويكفي النظر إلى عدم الالتفات إلى الكثافة السكانية ولا الثروات ولا المياه ولا منفذ بحري، خصوصاً لما سُميا بإقليمي سبأ وآزال.
وأثار تقسيم الأقاليم اعتراضاً شديداً من قبل الرئيس الراحل، إذ كان مصراً على استمرار الوحدة بصيغتها الاندماجية من دون إعادة نظر مهما كلف الأمر، لأنه كان يرى فيها منجزه التاريخي الأكبر، وبدت له محاولة التقسيم إنهاءً لهذا التاريخ، ولم يقتنع أن الدولة الاتحادية لا تعني إعادة اليمن إلى مرحلة التشطير، وفي نفس الوقت كان الرئيس هادي يرى فيها منجزه الذي يلبي مطالب وتطلعات الكثير من أبناء اليمن خصوصاً المناطق الواقعة جنوب إقليم آزال، وكذلك الفرار من قبضة صنعاء الخانقة.
بعد هذا بدأت في مدينة أبوظبي لجنة إعداد الدستور أعمالها برئاسة إسماعيل الوزير، وشارك فيها عدد من الخبراء القانونيين من ممثلي الأحزاب والمستقلين، واستندت في عملها إلى حصيلة توصيات مؤتمر الحوار التي كان كثير منها طامحا حد الجموح في رغباته من دون إدراك للحقائق والإمكانات، وأنهت عملها بعد زيارة قام بها إلى مقر عمل اللجنة جمال بنعمر وأحمد بن مبارك، وتحفظ الدكتور عبدالرحمن المختار ممثل الحوثيين الذي رفض التوقيع على المسوَّدة.
وتزايدت الخلافات بين رئيسين، أحدهما يعتمد على إرثه ونفوذه في مؤسسات الدولة، وآخر أوصد الأبواب على نفسه نتيجة تجربته إلى جوار صالح، والتي جعلته شديد الشك في كل من عمل مع صالح ومؤسساته، وخصوصاً تجنب المطالب المادية التي اعتاد صالح تلبيتها لكبار رجالات القبائل الشمالية، ومن المهم إدراك أن تجربة الرئيس هادي إلى جوار صالح لم تكن إيجابية لأسباب شخصية وأيضاً موضوعية.