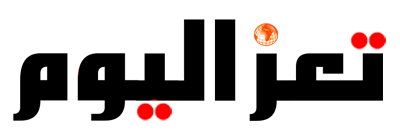دراسة بعنوان “الديناميات الاحتجاجية الجديدة في الوطن العربي: الفن الاحتجاجي نموذجًا”
يعيد “تعز اليوم” نشر دراسة للباحث د.رشيد أمشنوك بعنوان “الديناميات الاحتجاجية الجديدة في الوطن العربي: الفن الاحتجاجي نموذجًا” نقلاً عن موقع مركز دراسات الوحدة العربية.
ملخص: تتحدث هذه الدراسة عن ماهية الفن الثوري وأشكاله وتأثيراته الاجتماعية السياسية، وتبحث في تجليات حضوره في ديناميات الربيع العربي ومخاضاته، وتؤكد أن استحضار الفن، بقوالبه المتعددة ومجالاته المختلفة، في سياق النضال السياسي ضد المنظومات الرسمية، أصبح يشكّل خيارًا نضاليًا ملحًّا واختيارا احتجاجيا ضروريا، في ظل محدودية الحراك الشعبي التقليدي وضعف تأثيره في عصر “التقانة والاتصال”. من هنا أصبحت الحاجة ماسة إلى نضال فني موازٍ لمقاومة كل مظاهر الازدراء واللامساواة وغياب العدالة وغيرها من تجليات الانغلاق السياسي ورموز الاستبداد.
الكلمات المفتاحية: الفن، الاحتجاج، الثورة، المقاومة السياسية، الربيع العربي.
مقدمة
لكل ثورة فنونها، فهي رموز جمالها، ومعايير قوتها وتأثيرها؛ لذلك غدت رهانًا ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا وبديلًا لثورات الربيع العربي أو أشكالًا في صلب صيرورتها. وقد شكلت اللحظة السياسية الراهنة في البلدان العربية مرحلة تاريخية مهمة في اختبار الوعي الثوري الشعبي الذي تعبر عنه تلك الدينامية الفنية، بما هي دينامية سياسية واجتماعية بديلة لمقاومة واقع سياسي منغلق على ذاته، ولا يأبه إلا لأدلوجة تكريس اختيارات الأمير وخطاباته التقليدية.
تعتبر إذًا هذه الدينامية السياسية البديلة مجالًا لصقل إبداعات الشباب التواق للحرية وتحرير إرادته، في ما يخدم أهداف الثورة ويحقق أهدافها المطلبية. لهذا أصبح المجال الفني من أهم الواجهات الثورية أو بالأحرى قناة سياسية فعالة لرسم معالم مناكفة شعبية قوية.
حظي هذا الموضوع باهتمام كبير من قبل العديد من الدارسين والباحثين[2]؛ إذ نلفي هذه الإسهامات العلمية تعالج تيمات متنوعة تعبر عن الفن كملاذ اجتماعي واختيار سياسي معارض لبلاغة السلطة ونسقها الرسمي، من بين هذه الفنون التي حبلت بها الساحة السياسية العربية نذكر: الغرافيتي، الفن التشكيلي، الشعارات أو ترانيم الثورة، أهازيج الملاعب، الكاركاتور، السخرية السوداء وغيرها من أشكال الممارسة الاحتجاجية الفنية.
تهدف إذًا هذه الدراسة إلى التعريف بالفن الثوري، كشكل من أشكال المناكفة الشعبية والمقاومة السياسية، والتطرق إلى أساليبه وقوالبه، باعتباره يشكل حقلًا ثقافيًا واجتماعيًا للتفاعل الرمزي المؤثر، كما يعد رافدًا مهمًا في بناء وعي ثقافي وسياسي واجتماعي مناهض لقيم الاستبداد ومداراته، وقناة لتنشئة سياسية تؤهل المناضل وغيره من المتمردين الاجتماعيين بتعبير حنا آرندت[3] لتشكيل واقع ثقافي لا يستسلم لمقولات “السياسة الرسمية” وإنجازاتها أو لنقل بلاغة السلطة بتعبير عبداللطيف[4]، وعليه يمكن أن نعتبر الفن الاحتجاجي وفق مقترب “التفاعلية الرمزية” حلقة الوصل بين الفنان كفاعل اجتماعي رئيس مع محيطه وتحديدًا المنخرطين في مسار الثورة/النضال، مما يعطي للفن بعدًا قيميًا واجتماعيًا بتفاعله مع مسارات النضال وتعبيره عن اختياراته المطلبية، التي يستمد منها معنى وجوده السياسي والاجتماعي المؤثر. لذلك فإحساس الفنان وإبداعه يتعمقان في التحامه بالفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها ويعبر عنها كما يقول همام[5].
فما الفن الثوري؟ ما مميزاته وتأثيراته الاجتماعية؟ وما هي أشكاله وقوالبه الثقافية؟ وما تأثيراته السياسية؟
منهجيًا، توقفنا عند تحليل نقدي لبعض أشكال الاحتجاج الفني، التي شهدتها الساحة السياسية العربية ابان الحراك المعروف إعلاميًا بـ”ربيع الشعوب”، منطلقين نظريًا من المقترب السوسيولوجي الذي يعتبر أن الظاهرة الفنية تشكل جزءًا من الواقع الاجتماعي، أو هي الواقع ذاته في بعده الرمزي بتعبير المؤرخ البريطاني أرنولد هاوزر، وبالتالي فدراسة العمق الاجتماعي للفن وأبعاده الثقافية والسياسية، يعَدّ مدخلًا إيبيستيمولوجيا مهما لفهم المجتمع بتعبير أنجليز وهغسون[6]؛ إذ إن العلاقة بينهما هي حجر الزاوية للدراسة السوسيولوجية للفن، باعتباره حقلًا اجتماعيًا وثقافيًا، يعكس تناقضات المجتمع وتفاعلاته وصراعاته ومختلف بنى السلطة الرمزية كما يقول بورديو[7].
ونفترض أن محاولة فهم “الفن الاحتجاجي” سوسيولوجيًا، في السياق السوسياسي العربي، وتحليل بنيته الثقافية ودراسة توظيفاته وقوالبه الاجتماعية ومناسباته وخطاباته السياسية، يمكن أن يمثل حلقة معرفية مهمة في ما يسمى “الحركات الاجتماعية الجديدة” التي تتخذ من الفن السياسي بديلًا ناجعًا ومؤثرًا ومستدامًا لأي فعل احتجاجي كلاسيكي.
أولًا: معالم الفن الثوري الاجتماعي
1- تعريف الفن
يعتبر “الفن بمثابة نشاط ذهني وظاهرة اجتماعية خلاقة، ذات فاعلية إبداعية متجددة في المعنى وفي المبنى”[8]. إذ يملك القدرة على أن يجدد نفسه باستمرار ليواكب تحولات العصر ومستجداته، ويجاري إيقاع الجماعة التي تحدد معالمه الثقافية ومستواه الاجتماعي، ويتوق بالإنسان إلى قيم ورؤى فكرية وجمالية حديثة تليق بوجوده المتفرد. وبالتالي يمكن القول بأن الفن يعكس وعي الجماعة الفنية المناضلة وتفاعلها مع محيطها السياسي، وأي تغير في البنية التحتية (الواقع الاجتماعي) يستتبعه تغير في هذا الوعي الثقافي إذا استعرنا لغة الجدلية المادية كأنموذج لتحليل علاقة الفن بالواقع المحايث[9].
لا يمكن إذً أن ننظر إلى الفن كمجرد حرفة أو مهنة كما هو معروف في السياق الإغريقي، أو مجالًا للترويح عن النفس وتحقيق توازنها الوجداني كما يزعم أرسطو، وليس واقعًا مزيفًا يجافي الحقيقة الاجتماعية كما يعتقد أفلاطون أو نشاطًا ميتافيزيقيًا كما يراه الفيلسوف الإيطالي أغامبن مستعيدًا تصور نيتشه[10]، لكنه في المقابل استحال الفن ظاهرة اجتماعية وسياسية ملازمة للثورات والانتفاضات الشعبية ضد السلطة الحاكمة، بحيث أصبح أداة للاحتجاج ومساءلة السياسات الحكومية وتمرير المواقف الإنسانية والذود عن قيم المجتمع، وتنوير وعي أفراده وتحرير إرادتهم، والسعي نحو تقديم بدائل تنموية ومداخل للإصلاح السياسي الحقيقي.
لذلك أصبح قناة ثقافية مؤثرة وناشطية فنية موجهة بحسب ميا كراندل[11]، فالفن الاحتجاجي أكثر تعبيرًا عن بلاغة المهمشين والساخطين؛ ولا سيما حينما يلتقط من الواقع الاجتماعي المحايث لغته وهمومه وآهات أفراده. وينساق للمطالب الشعبية المشروعة، وهي الخلاصة الأساسية التي استشففناها من خلال دراستنا الموسومة بـ”الفن والاحتجاج: نحو فهم سوسيولوجي للفن الاحتجاجي في المغرب”[12]، إذ تأكد لنا أن قدرة الفن الاحتجاجي على استيعاب مطالب المناضلين والثوار، وعكس سخطهم الاجتماعي وامتعاضهم من واقع اللامساواة، هو ما يجعله مؤثرًا في النسق السياسي الرسمي، ومحررًا لإرادة الشعوب لتستفيق من وهدتها وجمودها، خصوصًا بعدما أن تبين ضعف “الحراك التقليدي” وعدم نجاعته.
2- الفن وعي محايث لإرادة الإنسان ومطالبه الاجتماعية
إذا كان الفن لا يخاطب في الإنسان إنسانيته ويعكس حقيقته الوجودية ويحمل معنى كرامته، يفقد قيمته الجمالية والأخلاقية وفعاليته الاجتماعية، ليستحيل قوالب جوفاء للإلهاء والتمييع والتدجين أو فنًا سوقيًا وزائفًا ومبتذلًا بتعبير غرينبرغ[13] (Greenberg)؛ حيث يكرس واقعًا ثقافيًا هجينًا، يخدم المنظومة السياسية الفاسدة ومقولاتها الثقافية التي تخلق لنفسها وعاءً فنيًا وثقافيًا يمرر خطاباتها وأفكارها، ويحقق رهاناتها المتموجة.
يقول محمد مصمولي في كتابه ها أنت.. أيتها الثورة: “نحن في زمن الثورة وما جاورها نؤمن بأنه لا ثورة من دون فن أو على الأقل بأن الثورة لا تقصي الفن بل هي في حاجة إليه… ونعني “بالفن” لا الرسم والغناء فحسب، وإنما بالثقافة بكل أشكالها الإبداعية وتجلياتها الرمزية”[14]. فحاجة الثوار للفن ليس ضرورة تنظيمية فقط أو بهدف بث روح الإبداع في حركتهم النضالية، لكنه اختيار ثقافي قيمي يسائل عبره الثوار سياسات الدولة ويعبرون عن ما تسميه ناتالي “السخط المعنوي”[15]، ذلك السخط الذي لا يرتبط مباشرة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للثائرين، بل بالشعور بالمعاملة الظالمة وغير العادلة كما تقول حنا أرندت في كتابها في الثورة[16].
وإذا كان الفنان بطبيعته يتطلع لبيئة ثقافية واجتماعية تعترف بقريحته الإبداعية المؤثرة، فإن التزامه بقضايا الإنسان وحقوقه حقق نوعًا من التفاعل المرضي بين إنتاجاته الفنية والثقافية والمحيط الاجتماعي الذي يعطي المشروعية للمقولات التي يتغنى بها أو ينحتها أو ينتجها، وهذا ما يجعل فنه ذات شرعية ثقافية واجتماعية كما يسميها بورديو، لأنه ملتزم بالتعبير عن قضايا الثوار في سياق سياسي معين، والإنسانية جمعاء حيثما وجد الإنسان.
ارتبط ظهور الفن بظهور الإنسان كما يقول “أرنست فيشر” في مؤلفه “ضرورة الفن”، ويكتسي أهمية بالغة في حياته، بل يرقى إلى مستوى الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فإذا كان الخبز والماء يلبيان الحاجات البيولوجية للإنسان[17]، فإن الفن يروي ظمأه الوجداني والعاطفي والروحي والمعرفي. والإنسان بطبيعته كائن رامز كما يقول إرنست كاسيرر، إذ لا يطيق الحياة المادية المباشرة وحدها، بل يتطلع دائمًا إلى حياة رمزية وعالم رمزي يصنعه بإبداعاته الفنية ولغته الرمزية ومجهوداته الذهنية العالية[18]. ويراه فيشر، أي الفن، بديلًا للحياة الواقعية المادية، ووسيلة لإيجاد التوازن بين الإنسان والعالم الذي يعيش فيه[19].
عن طريق الفن يمكن للإنسان أن يتحرر من فردانيته، ليعيش العالم بمنظار الآخرين، ليتخلص من ضيق “الأنا” ويترفل في حلل المشترك الاجتماعي. الفن إذًا كما يتصوره فيشر وسيلة للاندماج الاجتماعي، وقناة رمزية يتجاوز بها الإنسان فجاج تقوقعه وانغلاقه الذاتي، ليهتم بالآخر والمجموع، ويسائل كل ما من شأنه أن يعكر صفو الحياة الاجتماعية. وبالتالي يصبح الواقع الاجتماعي في قبضة الفنان أو بتعبير زكي نجيب محمود يستحيل الفن في خدمة “الاجتماعي”؛ إذ يرى في مقالته “رسالة الفنان” أن “الفن له رسالة اجتماعية، ولا يمكن أن تقوم حضارة بدون فن، كما أنه لا حضارة بغير اشتراك الفنان في صياغة هذه الحضارة…ورسالته كذلك أن يخاطب المجتمع الإنساني بشكل عام”[20]؛ بحيث ينخرط الفنان في تفاصيله ويترجم مشكلاته وآهات أهله، ويقوم بصوغها في قوالب فنية تخلدها ويتطلع بها الإنسان إلى تغيير وضعه وتثبيت قيم أخلاقية يستعيد بها مركزيته وكرامته.
تتحقق في الفن إذً إنسانية الإنسان كما يقول نصر حامد أبو زيد، طالما يمكنه من تشكيل عالمه من جديد متحررا من سطوة الثقافة السائدة والمفاهيم المتوارثة المفروضة. إن الإبداع لبيب الفن، إنه وطن الحرية كما يقول الفنان المغربي غلام[21].
2- الفن خطاب ثقافي وسياسي مقاوم
إن الفنان الملتزم مولع برصد جروح المجتمع وانكسارات الواقع الاجتماعي البئيس؛ بحيث ينتقده ليتحرر من ضحالته ويؤسس لواقع رمزي بديل يمتح منه قوته وصلابة مواقفه، ويتشوف لعالم اجتماعي يرأف به وبسكانه. الفنان لا ينبري لنقد محيطه الثقافي والاجتماعي والسياسي فحسب، بل ينتقد حتى معاول وأدوات نقده، إذا استعرنا لغة النقد المزدوج عند الخطيبي، فالنقد الذي يحمله الفنان هو نفسه النقد الذي ينافح عنه المثقف العمومي كما يسميه عزمي بشارة؛ إذ يتجاوز اختصاصه المعرفي لينخرط في التفاعل مع قضايا المجتمع مؤكدا وجوده المؤثر في الفضاء العمومي[22]، وبالتالي فالتموقع الاجتماعي للفنان الملتزم بقضايا مجتمعه، مرتبط بشكل مؤكد بالحس النقدي الذي يميز منتوجه الفني أو ما يسميه بورديو “الممارسة الانعكاسية”[23]، وبصدق مواقفه وواقعيتها فضلًا عن وجاهتها وصلابة منطلقاتها، كي تحظى بقبول الجميع، وبهذا يكون الفنان قائد التغيير وشمعة مضيئة في بحر لجّي، تستنير بها الإرادات المناضلة والثائرة التواقة لغد الحرية والكرامة[24].
3- فن جماهيري وقناة لتفاعل شعبي شاسع
فضلًا عن الحس النقدي الذي يسم الفن الاحتجاجي، يمتلك الفنان حاسة فنية وجمالية[25] في تلمُّس واقع مجتمعه وهمومه وقضاياه، لذلك يسعى إلى ترجمتها في أسلوب فني يعمل على إيصال رسالته بطريقة أكثر جاذبية[26]، وبما يساهم في توضيح الرسائل السياسية للجمهور المتلقي الذي يغلب عليه العامة من الناس، ممن لا يفقهون في تعقيدات السياسة ومداراتها المظلمة، وبالتالي يشكل الفن دورًا حاسمًا ومحوريًا في التعريف بالقضايا والمطالب التي يناضل من أجلها المحتجون بحس نقدي[27]، فضلًا عن قدرته على شحذ هممهم للانخراط في مسار النضال والالتفاف بجموع المناضلين[28].
لذلك فحينما يفقد الفنان هذا الوعي الاجتماعي والانهمام بهموم مجتمعه وقضاياه السياسية، يتحول إلى محض تقني أو مهني يتموقع خارج الأحداث التاريخية، كما الحال بالنسبة إلى المثقف الذي تتعطل وظيفته حينما لا يسخر كفاياته الفكرية وإمكاناته المعرفية في تنوير وطنه والمساهمة في تحررها من أسر ما يهدد حاضرها ومستقبلها.
4- مقاومة سياسية استراتيجية واختيار فعّال
إن إقحام الفن في ثورات الربيع، وفي كل أشكال الاحتجاج التي شهدتها الساحة السياسية العربية، يعبر عن دكاء القادة في كسب رهان الاحتجاج المؤثر في النسق السياسي، ويشي بفطنة المناضلين لتحقيق “دينامية احتجاجية ناجعة” تساير الإيقاع البطيء للأنظمة السياسية في التفاعل مع مطالب الشعب، ولا سيما أنها تراهن على السأم الذي يفترض أن يدب في نفوس الثوار، وتتآكل القواعد وتتراجع العزائم، لكن بتغيير أساليب التعبير الاحتجاجي وخوض معارك فنية رمزية، تصبح جدار المقاومة والمناكفة المجتمعية أكثر متانة وصلابة وأقدر على تجاوز لحظات النكوص والتراجع التي تعترض مسارات النضال الشعبي. وتستحيل بذلك رهانات الأنساق السياسية التقليدية واهية وغير قادرة على إيقاف “الحراك الثقافي والفني السائل”، الذي يخترق الأذهان والقناعات والاختيارات.
إن الفن بقدر ما يأسر الإنسان ويقيده بجماله، فهو يحرره من الخوف والتوجس والشفقة كما يقول أرسطو[29]، لذلك يعتبر ملاذ المناضلين والثوار ليستعيدوا ثقتهم بممارستهم الاحتجاجية، ويهبّوا لنصرة عدالة قضيتهم والدفاع عن بقائها في العلن ترفرف في قنوات الإعلام والتواصل الاجتماعي. إن الفن ثوري بطبيعته، ليس فقط لأنه يمكن الإنسان من معرفة حقيقته، بل لقدرته على تغيير البنى الثقافية والأنساق الاجتماعية والمنظومة السياسية الاستبدادية الفاسدة. وبالتالي فالتنويع في أشكال الاحتجاج والنضال صار رهانًا استراتيجيًا ضروريًا، كي لا تخبو جذوة الثورة الشعبية، التي تحتاج إلى قيادة فنية تساير خطاب الاحتجاج وتملأ البياضات وترمم الصفوف، وتخلد الذكريات الثورية التي يفرزها أي تفاعل سياسي أو اجتماعي مع مطالب الثوار.
ولأن واجهات الأنظمة السياسية الكليانية جمة؛ إذ تشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية للمواطنين، فلا بد من استراتيجية احتجاجية تكون شاملة وكفيلة بتحقيق مطالب المحتجين، التي لا تتوقف عند مستواها الاجتماعي المحض، لكن تستهدف إنجاز تغيير بنيوي يشمل مختلف البنيات الثقافية والسياسية والخطابية والاجتماعية التي تكرسها الأنساق السياسية. إن الفن بحمولته الثقافية والاجتماعية يمكن أن يساهم في تحقيق ما تراهن عليه الثورات العربية، من خلال بث الروح في ديناميتها السياسية، ومجاراة إيقاعها، ولملمة كل فرقة مهددة لوحدة خطابها وفلسفتها.
ثانيًا: فنون الثورة والاحتجاج
شهدت ثورات الربيع العربي أشكالًا جديدة من الاحتجاج، يعتبرها البعض أكثر تأثيرًا في بلاغة السلطة، مقارنة بالأشكال الكلاسيكية المألوفة. إن الثورة في العصر الراهن بدون فن ثورة غير مكتملة كما يقول الفنان السوداني عبد الهادي عبد الرحيم؛ لذلك وفرت الثورات العربية بيئة اجتماعية مناسبة لصقل المواهب الفنية وحفزها على البروز، كما حال مئات الفنانين الذين صدحت حناجرهم مستنكرين عسف الأنظمة وجور سلطتها، كما عبرت أناملهم عن سخطهم وامتعاضهم، فكانت النتيجة عشرات اللوحات الفنية المرسومة والمنقوشة والمنحوتة والمسموعة مخلدة دعوات العدالة والحرية والكرامة.
نلفي العشرات من هذه الفنون الثورية في مختلف بلدان الربيع العربي، ولا تكاد تجد ثورة بدون فنون تبث فيها الحياة لتواصل إيقاعها وديناميتها النضالية، ولأن الإصلاح مسار ويتطلب وقتًا طويلًا، لا بد من استراتيجية ثورية يكون للفن فيها موقع أساسي، باعتباره رافدًا مهمًا “لبلاغة الحرية” ولما يحمله من رسائل سياسية واجتماعية تدعم مشروع الثوار والمحتجين، وفي الآن نفسه يضمن استمرارية وهج الثورة كي لا يخمد فتيلها أو يتراجع مستواها، فتنقض عليها “الأنظمة السياسية المناكفة”.
لا أحد يجادل الموقع الهام والمؤثر الذي حظي به الفن في إنجاح الجولة الأولى من الثورات العربية، ولا زال يؤدي دوره في إنجاح جولات أخرى لتتحرر كل البلدان العربية من ربقة الاستبداد ونير منظومته الثقافية والمشروعية الاجتماعية والتاريخية التي يستند إليها ليبرر بها وجوده كخيار سياسي ضروري لمقولات “الاستقرار مع الاستمرار”. ولا شك أن هذه الأهمية هي التي رفعته إلى مقام الثورة، فصار يسمى “الربيع الفني” على غرار الربيع العربي، وهو ربيع لأنه أزهر إبداعًا مناكفًا لواقع سياسي منغلق، وأزهر إرادة مجتمعية تواقة إلى غدِ الحرية والكرامة والعدالة. وهو ربيع كذلك لأنه أعاد الإنسانية إلى إنسانيتها التي لا تنفصل عن توقها لقيم الجمال الحر المعبر عن واقعها الاجتماعي.
1- الحوائط تتكلم أو الاحتجاج الصامت
شكلت الحوائط وجنبات الطرقات وشوارع المدن العربية مجالًا للاحتجاج والتمرد ضد المعياري والرسمي منذ أمد بعيد. وقد برزت هذه الظاهرة الفنية إلى الوجود بشكل مثير في انتفاضات الشعوب الأخيرة، حيث كانت المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة سياقًا مناسبًا للإفصاح عن هذه الأشكال والتعابير التي تعكس “روح التمرد” والسخط والرفض والامتعاض من سياسات السلطة وبرامجها، كما تعبر عن الآمال والطموحات السياسية للشباب، مما ساهم في الارتفاع بها إلى الفعل السياسي كما يقول الدريسي[30].
يؤدي فن الغرافيتي وظائف كثيرة؛ من قبيل تصوير الأوضاع السياسية، ثم نقدها وتعريتها والكشف عن خباياها أو المسكوت عنه بحسب صياغة محمد أركون[31]، لذلك يشكل الحقيقة الاجتماعية المضادة للسلطة، والنموذج العكسي للمؤسسي والرسمي والمعياري، أو هو الفن الثوري الذي يؤدي دور الإعلام البديل حينما يدعو إلى مساءلة ما يذاع رسميًا، وما ينشر في قنوات السلطة.
تنطق الجدران والأرصفة بما لا تستطيع أن تنطق به الألسنة؛ وهو ما يبدو واضحًا للعديد من الباحثين في مضامين ما تحبل به الجداريات مصورةً مواقف الثوار من المنظومات السياسية الرسمية؛ ففي المدن المصرية مثلًا تجمل الباحثة ميا كراندل بعض هذه الصور الفنية في بحث بعنوان “ثورة الغرافيتي: فنون الشارع في مصر الجديدة” فضلًا عن خربشات تحيل على التمرد الشعبي، من بينها نذكر “يسقط يسقط حكم العسكر”، “يسقط المجلس العسكري الحرامي”، و”شعب يصنع ثورة.. شعب هيتفشخ”، “لا تصالح، عبارة مرفقة بصور القادة السياسيين”، “لن تقتلوا ثورتنا”، “الحرية Freedom”، “المجد للشهداء“، وغيرها من العبارات الكثيرة التي تزين حوائط المدن المصرية بمختلف اللغات، عاكسةً حجم السخط المجتمعي من المنظومة السياسية القائمة.
يجسد هذا الفن حسب البرماوي إرهاصات التحدي والشجاعة في صفوف الشباب الثائر، مع انحسار أسباب الخوف والمنع، وبزوغ ما يسميه بنية فرص سياسية مواتية، أهلت هذه الناشطية الإبداعية أو”الأرتيفيزم” كما ينعتها، لتبرز بصورة مثيرة حاملة في بنيتها الرمزية كل تكتيكات التنازع والصراع أو “سجلات الأفعال” بتعبير تشارلز تيلي. إن هذا الفن في نظر البرماوي يمثل رافدًا من نهر الحركات الاحتجاجية التي عرفتها مصر منذ مطلع الألفية الجديدة، لأنه عبّر عن صور الاعتقاد والسلوك الجمعي الذي عجزت قنوات التعبير السياسي والاجتماعي عن ترجمتها[32].
2- ترانيم الثورة أو الشعارات
الشعار “تعبير دعائي إعلامي مختصر ومثير للإعجاب”، يكرس فكرة ما ويسعى لنقلها بأبسط السبل والأشكال إلى جمهور المتلقين بغضّ النظر عن اختلاف ثقافاتهم السياسية وتنوع قدراتهم التواصلية، لكن في الدرس اللساني يعتبره نادر سراج مدوّنة لغوية، قائمة بذاتها، أو بمعنى آخر رسالة مكتفية بذاتها وتعبير أو علامة بليغة المضمون، مكثفة الشكل، وسريعة الإبلاغ والإيصال. تتعرض الشعارات والهتافات أحيانًا لتغييرات وتعديلات بما يناسب السياق والمناسبة الاحتجاجية، وبهدف إثارة الانتباه والتفكُّه والنقد والسخرية أحيانًا.
ويستمد الشعار قيمته من شعبيته وتعبيره السياسي الكثيف فضلًا عن قوته وعمق ما يحمله من دلالات اجتماعية. يقول سراج: “في المجال السياسي تصوغ الجماعة الشعار وتضعه بتصرف الجمهور المحتشد، ومتى ما راج الشعار واستمد شعبيته ومشروعيته من الوقائع السياسية الحدثية، ورديفتها المكانية الزمانية، بات متكأً لغويًا سائرًا ومرجع إسناد واسع الانتشار وسهل الاستحضار، مشافهة أو كتابة، عند محبذيه وموضوعًا قابلًا للتضفير مع سواه من الخطابات، بما في ذلك خرق القوالب اللغوية والتحوير…”[33].
يعرف الشعار بكيانَيه الشفهي العفوي والكتابي الموثقين، وبقدرته الإبلاغية المباشرة، لذلك فهو حمّال أوجه، ويمتلك بنية لغوية منسجمة مع الخلفية السياسية والاجتماعية والثقافية للمخاطب وقدرته الاستقطابية. حينما ينطق الشعار يدعى “هتافًا”، ويراعى في بنائه وتشكيله الوظيفة البرهانية للغة، لإقناع الجمهور بعدالة قضية ما أو موقف محدد.
إن اللغة الشعاراتية لا تكتفي فقط بوظيفة التشخيص والنقد أو استشراف الواقع السياسي والاجتماعي، بل يمكن أن تساهم في تحفيز المتظاهرين للانخراط بكثافة في الاحتجاجات، لذلك أول ما يراعى في صياغة الشعارات هو شعبيتها ومشروعيتها السياسية وقوتها البرهانية، فضلًا عن سلاسة التعبير عنه وترديده، لذلك يحرص المحتجون عادة كما تبين لنا من خلال ملاحظاتنا الميدانية للعديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات النضالية بالمدن المغربية[34]، على اختيار شعارات واضحة وبليغة وقوية، وتعيين لجنة خاصة بالشعارات تملك مؤهلات معينة كالصوت الجهوري والنبرة الجميلة والتنويع في تقديمها للجماهير. في هذا السياق يقول عماد عبد اللطيف: “إن قوة الثورات والانتفاضات تتمثل بالشعارات والهتافات والبيانات والتشكيلات الرمزية”[35]، وكلما حيدت قوة السلاح المادية هيمنت قوة الخطاب الناعمة على الثورة.
من الشعارات التي ترددها الشعوب نلفي ما يلي: “كلّن يعني كلّن”، “الشعب يريد إسقاط الفساد”، “صامدون صامدون.. لحقوقنا مطالبون”، “لا لا ثم لا للمافيا السياسية”، “عيفونا “أرهقتمونا” بالشعارات والحالة هي هي…”، “زيدونا فالمدارس باركا من البوليس…”، “حقوقي حقوقي دم في عروقي ولن أنساها ولو أعدموني…”، “إلّي بيقتل شعبو خاين”، “ممفكينش ممفكينش (لن نستسلم)…”، “إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر…”..
إن اللغة حسب عماد عبد اللطيف[36] بقدر ما تساهم في تزييف الوعي الجماهيري وتقييده وفرض السلطة عليه، تؤدي كذلك إلى تحريره ومقاومة أصنام الاستبداد التي تلغي فعاليته وقوته، “فالوعي النقدي – حسب عبارة عبد اللطيف – بالعالم يجعل الفرد قادرًا على التمييز بين الكلمات الطيبة والكلمات الرديئة، وقادرًا على إنتاج ما يسميه “الاستجابات البليغة”[37] التي تستهدف مقاومة خطابات التلاعب وتعريتها، بواسطة إنتاج خطابات بديلة”، وبالتالي فالشعارات التي يهتف بها الثوار في ساحات الانتفاضة، لا تعبر عن مجرد لغة خاوية يرددها المناضلون، بل هي نوع من المقاومة الفكرية لبلاغة السلطة وقاموسها، وهي مجال رمزي كذلك يثبتون عبره وجودهم السياسي والاجتماعي. يقول عماد: “الثورات سيول التغيير، وحين ينهمر السيل، فإنه لا يجرف أمامه شخوص العهد البائد وسياساته فحسب، بلا بلاغاته أيضًا، وبينما تشق الثورة لنفسها مسارًا جديدًا، تتشكل بلاغة جديدة؛ فالثورات تلد بلاغاتها”[38]. إن الشعارات هي بمثابة حرب بين بلاغتين متناقضتين في توجهاتهما؛ بلاغة الثورة التي تتوق إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبلاغة السلطة التي تتغنى بإنجازاتها وتنافح عن مشروعيتها السياسية والاجتماعية.
3- الفن التشكيلي
الفنان ليس مفصولًا عن واقعه، وليس نكرة في بحر إشكالاته وتحدياته الاجتماعية والسياسية، فحينما يوظف الفنان التشكيلي ريشته ليرسم لوحة فنية، فإنه يرسم الواقع الذي يحيط به، ويثير تساؤلاته الوجودية بعد فهم عمقها كما يقول الياباني هوكوزاي[39]، فعظمة الفنان في اعتقاده متمثلة بسمو روحه وحرية ريشته وعمق فهمه وإدراكه للأشياء[40]. فحضور الفن التشكيلي في سياق ما تشهده المجتمعات العربية من دينامية ثورية وخصوبة سياسية، يسير في هذا الاتجاه، حيث تغدو الصورة التشكيلية ثورة فنية، لأنها تعبر عن مخاضات المجتمعات وتترجم الرسالة الفنية الملتزمة بقضايا الشعوب.
وقد وثق الفن التشكيلي العربي منذ عام 2011، عشرات القصص والروايات المأسوية التي عاشتها المجتمعات العربية، في هذا السياق يرى الفنان التشكيلي، حسام علوم، “أن الفن التشكيلي أسهم في الثورة السورية، عبر الكثير من الأعمال، التي نستطيع القول إنها أرّخت للأحداث والقصص الإنسانية مع الشعب السوري بالتزامن مع تطور أحداث الثورة، ونشأت العديد من الأعمال التي حكت عن مطالب ومعاناة الشعب السوري منذ عام 2011 حتى اليوم”[41] وهو التصور نفسه الذي يعبّر عنه المئات من الفنانين التشكيليين في كل الأصقاع العربية، مما يؤكد الارتباط الوثيق بين الحقل الفني وما يسميه جاكوب سارابيا Jacob SARABIA بالمقاومة المجتمعية[42] . وبالتالي فحضور الفن التشكيلي في صلب الحركية الساسية الثورية هو “مقاومة بديلة” بتعبير Siobhán Shilton شيلتون شوفان[43] ، وهو إشارة كذلك لدوره الثقافي العميق في تحرير الإرادة الشعبية من طوق الخوف والعجز والكسل، ليهبّ المواطن لنصرة وطنه وينافح عن قضاياه الإنسانية
تزخر اللوحات الفنية العربية الموازية للربيع الشعبي بمعظم القيم السياسية والاجتماعية والمطالب الحقوقية التي يناضل من أجلها المواطن؛ فإلى جانب النقد الثقافي وتعرية المنظومة السياسية، نلفي مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة وغيرها من الحقوق والشعارات التي ترفع في ساحات النضال، إن الفن التشكيلي هو ثورة في حد ذاته، بما تعنيه الثورة من تغيير جذري لكل أشكال الفساد والاستبداد، وهو أداة مطواعة في يد الفنان يعكس بها القيم الجمالية والمواقف الإنسانية كما ترى بوهودي[44].
إن الفن حسب هربرت ماركوز لا ينحصر في بعده الجمالي الخالص، بل يستمد حقيقته كذلك من طبيعته الثورية التي تدفع الفنان إلى مقاومة سطوة المستبدين وعدم مشروعية مسالكهم السياسية وتعرية الانعكاسات السلبية للحضارة المعاصرة التي ينخرها الاغتراب[45]، ” فالعمل الفني وإن كان مرتبطًا بالواقع، فإنه يمثل في نفس الوقت ثورة عليه، لأنه وحده القادر على فضح الواقع وتعريته ووضع ذلك الواقع في قفص الاتهام منددًا بالظلم والجور الموجودين في الواقع”[46].
4- الأغنية الثورية
لكل ثورة أيقونتها الفنية، ومزمارها الذهبي، فالمغني هو الصوت الحر الذي يتغنى للثورات، منافحًا عن اختياراتها السياسية ومطالبها الاجتماعية والثقافية، فهو إما أن يكون مع حشود المتظاهرين مسخرًا خاماته لتزيين المسيرات ولإعطائها جمالية المقاومة بتعبير الباحثة شوفان شيلتون، كما الحال بالنسبة إلى الفنان السوري الراحل عبد الباسط الساروت الذي لقب بحارس الثورة وبلبلها قبل أن يُغتال، وآخرون يؤازرون الثورات العربية بحنجراتهم الذهبية، كالفنان المغربي رشيد غلام الذي غنى للشعوب العربية وللإنسانية جمعاء التواقة لغد الحرية والكرامة، ومن أغانيه ذات النفَس الثوري نجد: ” عاش الشعب عاش الشعب…”، ” عيون عبلة…”، “هنا غزة…”، “كنت بينا..”، “سجن القداسة”… وغيرها من الأغاني التي يعتبرها الفنان شكلًا من أشكال الالتزام الجمالي والقيمي بقضايا الإنسان العربي، الذي يئن تحت وطأة المنظومات السياسية الفاسدة.
لم تكن الأغنية الثورية وليدة الربيع الشعبي الذي عرفته البلدان العربية منذ 2011، بل إن حضورها قديم في التحركات الثورية التي شهدتها المجتمعات، ومن بين هذه الأغاني التي ألهبت الجماهير بنفَسها الثوري، نجد أغنية “وداعًا يا جميلة: بيلا شاو Bella Ciao” الإيطالية، التي تحكي عن الشاب الذي يستيقظ في صباح أحد الأيام مودعًا حبيبته ليقاتل من أجل الحرية، لتصبح ترنيمة للحرية والمقاومة، لكن يرى مؤرخون أنها تعود إلى عاملات جمع النباتات في الحقول احتجاجًا على ظروف العمل القاسية. ولشهرتها السياسية رددها الإسبان في حربهم الأهلية الممتدة، كما تغنّى بها الإيطاليون كثيرًا في تظاهراتهم وإطلالاتهم في زمن الحجر الصحي.
إن الذاكرة الثقافية والفنية للمجتمعات تحبل بالعديد من هذه الأغاني ذات الطبيعة السياسية، من بينها: “أغنية نيلسون مانديلا” التي حررته من قيود السجن بعد تفاوضه مع حكومة بلاده لإنهاء الأزمة، وأغنية “نحن أمريكيون أكثر” التي صدرت بالإسبانية عام 2001 للفرقة المكسيكية “نمور الشمال”، تنديدًا بالميز العنصري لبعض الجماعات الأمريكية التي تدّعي احتكارها للمواطنة بشروطها الخاصة، قاصية كل مظاهر التنوع العرقي والإثني الذي يميز أمريكا.
وفي الوطن العربي نجد أغاني فيروز وعبدالوهاب ومارسيل خليفة، وبوشناق بكلماته الشهيرة: “خدو الكراسي لكن خلوا لي الوطن”، وعوض النابلسي بأغنيته: «يا ليل خلي الأسير تيكمل نواحه» التي كتبها في ليلة إعدامه، وكيف صارت أغنية المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، وأغنية: “شيد قصورك..” التي غناها الشيخ إمام وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم، التي يرثي فيها أحوال مصر بعد الانفتاح، وكيف تحولت الآمال الثورية إلى سراب، وأغنية السوري عبد الوهاب الملا: “هالبلد مني ومنك”، وأخيرًا وليس آخرًا قصيدة: “إرادة الحياة” لأبي القاسم الشابي التي يرددها المتظاهرون في كل المجتمعات العربية، وقد غناها العديد من المطربين العرب.
لا شك أن الساحة الفنية العربية والعالمية تزخر بهذا النوع من الأغاني الملتزمة بقضايا الشعوب وبمصائرها واختياراتها القيمية والسياسية ومطالبها الاجتماعية، فهي تشكل حركة فنية ثورية موازية، ويمكن اعتبارها نسقًا ثقافيًا وسياسيًا مشاكسًا أو شكلًا من أشكال الرفض والمقاومة وعنصرًا مهمًا لإنجاح الثورة كما تقول الباحثة الإيطالية باولا كاندولفي PAOLA GANDOLFI[47]؛ ليس فقط لأن خطابها يحمل رسائل سياسية وإنسانية عميقة، وإنما كذلك لقوة تأثيرها في الوعي السياسي الشعبي وقدرتها على توجيه بوصلته الحقوقية، وبالتالي صرنا نتحدث عن معارضة سياسية خارج البنى المؤسساتية المعهودة التي لم تقم بدورها كما ينبغي ويقصد هنا سعيد بنيس مختلف الفاعلين السياسيين الذين يشتغلون في إطار المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية[48].
إن الحركات الفنية هي التي شكلت الإطارات المهة للحركات الثورية في نظر باولا غاندولفي (Paola Gandolfi)، فالفن سواء كان غناءً أو رسمًا أو نحتًا أو شكلًا آخر له القدرة برأي الباحثة على النفاذ إلى العمق الاجتماعي للثائر والتعبير عن تفاصيله ومحاكاته، وتعرية المسكوت عنه في نسق السياسة الرسمية وفضح مثالبه وعيوبه، وهو ما يساهم في تشكيل وعي سياسي ثوري يؤطر أي حركة احتجاجية ويرسم معالمها الحقوقية ورهاناتها المطلبية. ولهذه الأهمية التي تسم الفن والموسيقى العربية بالخصوص، يرى مارك لوفين (Mark le Vine) أن ظاهرة الموسيقى الثورية ويقصد هنا أساسا “الهيب-هوب” تعتبر مدخلًا أساسيًا لاستيعاب الديناميات الكامنة وراء الاضطرابات الثورية التي شهدتها المجتمعات العربية، منطلقًا من الإطار النظري لدور الإنتاج الفني في الثورات لرواد مدرسة فرانكفورت تيودور أدورنو (Theodor Adorno) ووالتر بنيامين (Walter Benjamin) عن إنتاج الثقافي وتداولها واستهلاكها[49].
5- أهازبج الملاعب وشعارات الألتراس[50]
شكلت أهازيج الملاعب وشعاراتها خطابًا احتجاجيًا مثيرًا للاهتمام السوسيولوجي، ولا سيما أن تأثيراته السياسية في المنظومات الرسمية باتت واضحة حسب بنيس حيث يساهم في “إعادة بناء الرأي العام”[51]، بالموازاة مع الحراك الشعبي الذي عرفته المجتمعات في السنوات الأخيرة، لذلك استحالت مجموعات “الألتراس” في نظر الباحث محاضن لتنشئة سياسية حديثة لما وجدت البنى السياسية التقليدية (الجمعيات، الأحزاب، المنظمات المدنية) غير قادرة على استيعاب استعداداتهم السياسية واختياراتهم الاجتماعية المطلبية، وبالتالي غدت الملاعب ملاذ الشباب الثائر للتعبير عن مطالبه، والإفصاح عن الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يناضل من أجله.
تعكس لغة الأهازيج الشبابية داخل الملاعب الرياضية تذمر الشباب من السياسات الرسمية، كما تبين هذه النماذج: “ما بغيتونا نقراو (لا تريدوننا أن ندرس)”، ما بغيتونا نوعاو (لا تريدون أن نعي)، ما بغيتونا نخدمو (لا تريدون أن نشتغل)”، ” جيناكم من اللخر…هاد البلاد عايشين فغمامة”، “الهدرة طلعت فراسي وغير فهموني…”، “لمن نشكي حالي”، “الحرية اللي بغينا يا ربي…”، “الشعب محكور..كيفكر فالبابور…”، “في بلادي ظلموني…”، وغيرها من الشعارات والأغاني التي تؤدي بشكل جماعي في مدرجات الملاعب، بل وفي كل أشكال الاحتجاج الشعبي.
تعبر هذه الشعارات عن تحول واضح في الخطاب الاحتجاجي للجماهير الرياضية، التي كانت ترفع لردح من الزمن أهازيجها الثورية ولافتاتها رفضًا لقرارات المؤسسات الرياضية أو فلسفة تدبيرها لفرقها، لتصبح الآن ذات طبيعة سياسية وحقوقية محضة، وإن كانت تتم في أجواء ترفيهية وحماسية. ومما لاشك فيه أن هذا الانتقال الخطابي له أسباب عديدة، أهمها تراجع دور الوساطة الذي تضطلع به المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، فضلًا عن غياب فاعلية سياسية إيجابية كفيلة باستيعاب تطلعات الشباب وطموحاتهم، هذا إلى جانب الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تعطي لهذه الديناميات الاحتجاجية مشروعيتها. ثم أخيرًا وليس آخرًا ما يسميه عالم الاجتماع الاسباني مانويل كاستلز بحراك الشبكات[52]، حيث أصبح “المجتمع الشبكي” في نظره يكتسي أهمية بالغة في التعبئة والحشد إضافة إلى محاجّته على قدرة هذا الفضاء على فرض نمط معين من التغيير السياسي والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي[53]. كما يجسد مختبرًا لاحتجاج عابر للحدود ومنفتح على جميع السياقات والقضايا، التي تشكل فرصة التشبيك والاتصال والتشارك وأداة للتمرن السياسي والانخراط الجماعي في المنافحة عن القضايا السياسية والاجتماعية المشتركة.
في السياق نفسه يرى الباحث في العلوم الاجتماعية سعيد بنيس أن هناك خمسة مؤشرات دون حصرها، تكفي لاستشراف الخطاب الاحتجاجي للألتراس في المغرب، وهي الاحتباس القيمي، والحرمان الاقتصادي، والارتباك المجتمعي، والنفور السياسي الواقعي للشباب، ثم أخيرًا إعادة تسييس الألتراس عبر بوابة الافتراضي من خلال تنشئة افتراضية مبنية على حقائق معيشة[54]. وهي أسباب وتحديات مجتمعية تفرض في نظره ضرورة الاستعجال في بلورة نماذج تنموية قادرة على التفاعل الإيجابي مع مطالب الشعوب.
إذا كانت الحركة الاحتجاجية في نظر عمرو الشوبكي هي كل الأدوات التي يبتكرها المحتجون للاعتراض والرفض والمقاومة لكل الضغوطات السياسية والاجتماعية[55]، وما دام أن هذه المجموعات الفنية تروم تحقيق تغيير سياسي منتظر، فإن هذه الممارسات الفنية، بما هي تعبيرات احتجاجية، لا تقل أهمية عن الأشكال الكلاسيكية من المعارضة سواء داخل نسق المؤسسات أو خارجها، من هذا المنطلق استحال الفن الثوري قوة أساسية لكسر شوكة التسلط والدعوة إلى الإصلاح والتغيير، ولا سيما أنه يعبر عن مطالب المهمّشين، وينحاز لتطلعاتهم، والمهمّشون كما يقول إريك هوفر هم حجر الزاوية في بناء عالم جديد[56]، وهم خميرة التغيير بتعبير استاتي[57].
خاتمة
تأسيسًا على ما سبق يمكن القول إن قدرة الفن الاحتجاجي على ترجمة مطالب الفئات الاجتماعية المهمشة، قد يجعل منه حراكًا اجتماعيًا موازيًا يضاهي تأثيره الديناميات الاحتجاجية الكلاسيكية، وبالتالي فحضوره كشكل من أشكال النقد السياسي والثقافي، ليس غاية في ذاته، وإنما أصبح رهانًا استراتيجيًا ضروريًا “لتحقيق “الاستدامة الاحتجاجية”، وهو ما تبين بجلاء في ما بات يسمى إعلاميًا “الربيع العربي”؛ إذ لا يخلو أي تحرك شعبي إبانه من “فنون الاحتجاج وأشكاله”، لذلك شكّل بمثابة مختبر سوسيولوجي لإدراك موقع “الفن” في منظومة الالتزام بقضايا الشعوب ومصائرها.
ما درجنا على ذكره في متن هذه الدراسة من أشكال الاحتجاج والمقاومة السياسية الجميلة، يؤكد أن المنظومة القيمية والثقافية التي يحيل عليها الفن هي التي تضفي عليه قيمة اجتماعية، وتقوي من مشروعيته في بحر “المناكفة المجتمعية” لكل مظاهر الاستبعاد الاجتماعي والانغلاق السياسي، إضافة إلى فعاليته النضالية ونجاعته في تعبئة الجماهير الشعبية وشحذ هممها السياسية، فضلًا عن تأثيره النفسي العميق، إذ الفن لا يعبر فقط عن الاختيارات الاجتماعية لرواده، وإنما يساهم في إيقاظ الإرادات الخاملة من وهدتها، لتنخرط في مساءلة ذاتها ومحيطها والمنظومة السياسية المهترئة التي ترعاه. وبالتالي يصبح “الفن” بمثابة محرك سياسي للديناميات الاجتماعية التواقة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
يضاف إلى ذلك أن قوة “الفن الاحتجاجي” في واقعيته السياسية ومحايثته لهموم الثوار، مما جعله “فنًا شعبيًا وجماهيريًا”، لما له من إمكانات على فرض وعي سياسي معين يقض مضجع الأنظمة السياسية، ويحارب “انغلاقها” والتفافها على مطالب الشعوب، وبالتالي فاستمرارية هذا النوع من الفن مرتبطة بالبيئة التي يتفاعل معها، وهو ما يبرر حضوره الكثيف والمثير في سياق الدينامية الاحتجاجية التي انطلقت في سنة 2011 في بعض البلدان العربية.
في الختام، يمكن التأكيد أن هذه الدراسة كان هدفها الأساس هو التعريف “بالفن الاحتجاجي الثوري من خلال بعض أشكاله وتأثيراته السياسية والاجتماعية”، ولم يكن مرمانا التفصيل في ذلك، لذلك يمكن الإشارة في الأخير بأن هذه الفنون تستحق دراسات علمية مفصلة متخصصة وبمختلف المقاربات المعرفية، لمعرفة تداعيات الثورات على الحقل الفني، ومساءلة دور هذا الأخير في مجاراة إيقاعها وعكس مطالب الشعوب الثائرة وتقويض دعائم المنظومات الفنية والثقافية المضادة للتيار الفني الملتزم.
المصدر : مركز دراسات الوحدة العربية .