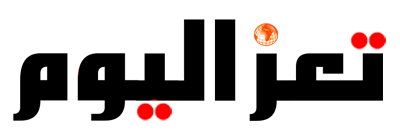هل لا يزال التكامل التنموي الاقتصادي العربي مطلبًا ضروريًا؟
حين صدر العدد الأول من المستقبل العربي في أيار/ مايو 1978، كان ما يشغل الفكر الاقتصادي العربي هو الإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكن تفعيل الاتجاهات الخاصة بعمليتَي التنمية والتكامل الاقتصادي، التي تم الربط بينهما بتعبير «التكامل التنموي»، وكيف يمكن استخدام أموال النفط العربي من أجل هذه القضية؟.
متابعات – تعز اليوم:
دارت معظم الكتابات والبحوث الاقتصادية حول هذا الموضوع، وانتقل الاهتمام به أيضًا إلى الأوساط الرسمية في البلدان العربية، وإلى الجامعة العربية ومؤسساتها ومجالسها ولجانها. وحظيت الكتابات في المستقبل العربي بجانب مهم من هذه الكتابات والبحوث منذ صدور العدد الأول.
كان الوسط الشعبي العربي، مهتمًا بهذا الموضوع، وبخاصة بعدما ساد نوع من التفاؤل في أجواء فرضتها حرب 1973، حيث استُخدم سلاح النفط لأول مرة، وهو ما كان له أثر شديد الوطأة في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه توافر لدى البلدان العربية المصدرة للنفط «فوائض مالية» مهمة نتيجة ارتفاع سعر النفط الذي سببته تلك الحرب إلى جانب عوامل أخرى. وكان من النتائج الاقتصادية لذلك، تخصيص البلدان النفطية معونات سنوية لبلدان المواجهة العربية. وما رافق ذلك من تدفق أموال من العاملين العرب في البلدان النفطية بعد التوسع الحاصل في اقتصاداتها، وحاجتها إلى الأيدي العاملة الموجودة فعلًا في البلدان العربية المرسلة للقوى العاملة كمصر والسودان والأردن ولبنان سورية.
ومع التوسع بإحداث المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية في إطار جامعة الدول العربية، كالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد العربي، والاتحادات التي تغطي جانبًا مهمًا من جوانب العملية الاقتصادية، أحدثت أيضًا المعهد العربي للتخطيط، وازداد الاهتمام بالجوانب النظرية للعمل العربي المشترك، وكان من بين هذه الجوانب مسألة التكامل الاقتصادي العربي وارتباط ذلك بالتنمية العربية.
وقد انتقل الاهتمام بالجانب الاقتصادي إلى أعلى مستويات السلطة في البلدان العربية، فعقد في عمان «مؤتمر القمة العربية» عام 1980، وهو أول مؤتمر اقتصادي بهذا المستوى يعقد لمعالجة القضايا الاقتصادية، وتم الربط أول مرة بين الجانبين الاقتصادي والسياسي على نحو واضح، من خلال إيجاد القواسم المشتركة ما بين الأمن القومي والإنماء الاقتصادي، كما تم التشديد على مبدأ التخطيط القومي كأسلوب لتوجيه وتنظيم العمل العربي المشترك ضمن تصور شمولي تنموي مترابط ومتكامل، وذلك من خلال إقرار المؤتمر لأربع وثائق أساسية وهي:
وثيقة استراتيجية العمل العربي المشترك بأهدافها وأولوياتها وبرامجها.
ميثاق العمل الاقتصادي القومي.
عقد التنمية العربية المشتركة «وخصص له مبالغ كبيرة».
الاتفاقية العربية الموحدة للاستثمار.
اتفقت آراء النخب الاقتصاديين العرب، على أن هذه الوثائق تكفل لدى تنفيذها نجاح مسيرة العمل العربي المشترك، ومن شأنها خلق المناخ والإطار الملائم لتطويرها وإبعادها من الهزّات السياسية والخلافات الطارئة. إلا أن المحظور قد وقع؛ فقد اتجهت الدوائر الرسمية في البلدان العربية نحو توجهات أخرى تنسجم وتتوافق مع الإرادة الغربية والصهيو-أمريكية، فأحدث في بداية ثمانينيات القرن الماضي المجلس التعاون الخليجي، كما أحدث في نهاية الثمانينيات اتحاد المغرب العربي، واتجهت مصر والأردن والعراق وتاليًا مصر والأردن وتونس والمغرب إلى إيجاد نوع آخر من الترابط، كما ازداد التوجه المصري نحو أفريقيا. مع الحرص على علاقات وثيقة ببلدان الخليج. وبقيت وثائق القمة والاتفاقات الاقتصادية المختلفة في دهاليز جامعة الدول العربية ومنظماتها المحكومة بالروتين والبيروقراطية، وطغى عليها النسيان.
لذا، سادت الأوساط الأكاديمية الاقتصادية والسياسية، أسئلة كثيرة حول أسباب الإخفاق في تحقيق أي مستوى مقبول من مستويات التكامل الاقتصادي والتنموي العربي، رغم القرارات والمواثيق المتعددة التي أصدرتها جامعة الدول العربية ومجالسها المختلفة، وبالتحديد فقد ساد هذه الأوساط سؤال مركزي حول أسباب عجز القرارات والمواثيق (العربية) أمام «جبروت» الهياكل القطرية المتمترسة خلف شعارات زائفة حول السيادة الوطنية، وأمام البيروقراطية الحكومية والفساد التي طالما وقفت حائلًا دون تنفيذ الاتفاقيات العربية، في حين «تهرول» لاهثة من أجل تنفيذ الاتفاقيات المعقودة مع البلدان الأجنبية والمنظمات الدولية. وقد تركزت الإجابة عن هذا التساؤل من خلال أطروحات متعددة أكاديمية أو سياسية، لتعيد أسباب الإخفاق في العمل العربي الاقتصادي المشترك إلى عوامل ذاتية وأخرى خارجية.
هذه العوامل مترابطة، لكنها تتمحور حول موقف الغرب ودول الاستعمار القديم والولايات المتحدة الأمريكية ومشروعها الاستعماري الجديد، ذلك الموقف الذي حال دون تحقيق أي شكل من أشكال الوحدة العربية، ووقف مناهضًا شرسًا للمشروع النهضوي العربي. وعمل على نحو حثيث على خلق (الكيان الصهيوني) ومده بأسباب القوة، وبالدعم السياسي والعسكري والعلمي.
وإذا كان هذا الموقف الغربي الأمريكي الصهيوني الاستعماري مفهومًا، فإن ما يجب التركيز عليه هو العامل الذاتي الذي أعاق دومًا العمل العربي المشترك (ومن أهم مرتكزاته التكامل التنموي)، كما أعاق محاولات النهوض والانعتاق من دائرة التخلف.
وإذا كان الحديث يطول حول هذا الموضوع، فإننا في هذه العجالة، نشير أساسًا إلى طبيعة الأنظمة العربية الحاكمة، التي رأت من مصلحتها التمسك بالدولة القطرية وتعزيز التجزئة، انطلاقًا، من مقولة المحافظة على «السيادة الوطنية» مدعومة بقوى خارجية، وبقوى الفساد وأصحاب المصالح في الداخل، مستفيدة من حالة الجهل والتخلف التي تعيشها الشعوب العربية، بما في ذلك تخلف المؤسسات السياسية. وقد ساعدها على ذلك، ميثاق جامعة الدول العربية الذي يعد قرارات الجامعة ومؤسساتها غير ملزمة، وعلى هذا سعت كل دولة عربية (منفردة) إلى نسج علاقاتها الخاصة ببلدان العالم والتكتلات الإقليمية، وفقًا لمصالحها القطرية الضيقة، وامتنعت، وتباطأت في تنفيذ متطلبات العمل العربي المشترك «بما فيه عمليات التكامل التنموي» بحجة تعارضها مع السيادة الوطنية، التي تناستها تمامًا في علاقاتها بالبلدان الأجنبية «وبخاصة بلدان الغرب والولايات المتحدة»، وفي علاقاتها بالمنظمات الدولية، من دون أي حرج بأن هذه العلاقات تنتقص من سيادتها الوطنية. فهي لا تتذكر سيادتها إلا عندما يتعلق الأمر في علاقاتها بالبلدان العربية الأخرى.
الجدير بالذكر أن ميثاق العمل العربي الاقتصادي «سبق الإشارة إليه كوثيقة من الوثائق التي أقرّها مؤتمر القمة في عمان عام 1980». إن هذا الميثاق أقر حيْد العمل الاقتصادي العربي المشترك، وإبعاده من الخلافات السياسية بين البلدان العربية «وهذا أمر غير ممكن وغير مسموح به»، كما أقر هذا الميثاق مبدأ «المواطنة الاقتصادية» ومعاملة رأس المال العربي والعمل العربي بما لا يقل عن معاملة مثيلها من أصل وطني في كل قطر عربي، وبما يحقق الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة للاستثمار العربي في أرجاء الوطن.
لكن هذا الميثاق وغيره من القرارات العربية، بقيت حبرًا على ورق، وبدلًا من أن تكون القمم العربية والمجالس عاملًا للوحدة والتآخي، أصبحت أداةً للتفرقة وزرع الفتن، وتبدّى ذلك حين استخدمت جامعة الدول العربية، غطاء للحرب على ليبيا، وحين أخذت قرارًا بتجميد عضوية سورية من مجلس الجامعة العربية ومنظماتها «مع أنها عضو مؤسس»، وغضت النظر عن العدوان عليها، وعن تمويل المنظمات الإرهابية من بعض بلدان الجامعة. وهذا يشير إلى سابقة خطيرة في العلاقات العربية وفي آلية عمل الجامعة والعمل العربي المشترك، وبخاصة أن الميثاق ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأعضاء. في حين أنها تسكت عن العدوان اليومي الذي تشنه السعودية والبلدان الحليفة لها على اليمن وشعبه.
فلا عجب والحال على ما ذكرنا، أن يتراجع العمل العربي المشترك، وأن يتم تجاهل التكامل التنموي، وتسلك الدول القطرية طريقها الخاص في علاقتها الاقتصادية ببلدان العالم، من دون أي مراعاة للمواثيق والقرارات العربية، بما في ذلك الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لا بل والمسارعة إلى ضخ الاستثمارات فيه بما يساعده على تجاوز أزمته الاقتصادية.
أولًا: التكامل التنموي بين الأقطار العربية ضرورة لا بد منها
مع اشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية (وبخاصة بعد أزمة 2008)، ومع أزمة وباء كوفيد - 19 تزداد الحاجة في جميع بلدان العالم، بما فيها البلدان العربية، إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية الداخلية، وإعادة رسم علاقاتها بالبلدان الأخرى في ضوء هاتين الأزمتين، آخذين في الحسبان الأمر الذي تركته السياسات الاقتصادية (تحت ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة كوفيد - 19) على الاقتصاد الوطني، والتطورات الحاصلة على صعيد النظام العالمي.
ثانيًا: آثار الأزمة والوباء في الاقتصادات العربية
نشير بدايةً إلى أن الأنظمة العربية، بدلًا من بناء اقتصاداتها على نحو مستقل، عمدت إلى ربط اقتصادها بالاقتصاد الرأسمالي العالمي، وبالتالي فإن هذه الاقتصادات كانت عرضة لما يتعرض له الاقتصاد العالمي الرأسمالي من أزمات، ويسري ذلك الاستنتاج على جميع البلدان العربية، وفي جميع المراحل، فيما عدا تجارب ذات توجهات اشتراكية تدخلية جرت منذ أواسط خمسينيات القرن الماضي، في مصر وسورية والعراق والجزائر وليبيا، وارتبطت تلك التوجهات بسياسات تحررية استقلالية. ولكن هذه التجارب لم تأخذ مداها، وكان أغلبها يتم من جانب السلطات التي سرعان ما اعتراها الوهن والفشل في الإدارة والفساد، والابتعاد من نبض الشارع، وانهارت الشعارات الاجتماعية الداعية للعدالة والمساواة، مع ربط التحرر الاجتماعي بالتحرر السياسي، وكان لا بد من ربط ذلك كله بتحرير فلسطين… لذا كان من الطبيعي أن تستغل القوى المعادية والصهيونية الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة. وبرزت حركات اجتماعية بسبب سوء الأوضاع الاجتماعية، فكان أن وصلت تلك البلدان إلى ما وصلت إليه من فوضى أدت إلى تنامي الحركات الأصولية والتكفيرية، وإلى دخول هذه الحركات ساحة الصراع مزودين بالقدرات اللوجستية والتسليحية من القوى المعادية، وهكذا أضيف إلى سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عنصر آخر يتمثل بالصراع السياسي المدعوم بالسلاح. وللأسف فقد استخدمت بعض الأنظمة العربية (وبخاصة الخليجية) للقيام بدور المزود لهذه الحركات الأصولية، ومن المفارقات أن مساعداتها لتلك الحركات جاءت تحت عنوان الحرية والديمقراطية، في الوقت الذي تمارس فيه على شعبها أقسى أنواع الحكم الجائر. وهكذا توحدت الأنظمة العربية، في تبعيتها للنظام الرأسمالي العالمي، كما توحَّدت سياساتها في تحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات ريعية غير منتجة، لتستمر في تبعيتها للغرب، رغم أنها قادرة على نسج علاقات بجميع أنحاء العالم. وقد جعل الاقتصاد الريعي الذي خيّم على الاقتصادات العربية، مرتبطًا بسوء توزيع الدخل وعدم العدالة في توزيع الثروة، وانسداد أفق التطور والتقدم، وقعَ الأزمة الاقتصادية العالمية، وتاليًا وقع أزمة الكورونا، قاسيًا وشديدًا.
فالبلدان العربية التي تبلغ مساحتها الكلية 13.3 مليون كم2 (9.6 بالمئة من مساحة العالم) والتي يسكنها 400 مليون نسمة (5.4 بالمئة من سكان العالم)، يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2347 مليار دولار (بالأسعار الجارية) فقط، أي أن متوسط نصيب الفرد من الناتج يبلغ 6420 دولارًا فقط (وهذا الوسطي يخفي حقيقة التفاوت الهائل في الدخول وتوزع الثروة)، وتملك البلدان العربية 55.6 بالمئة من احتياطي النفط في العالم و27.7 بالمئة من احتياطي الغاز الطبيعي، وتبلغ عوائد الصادرات النفطية بالأسعار الجارية أكثر من 308 مليارات دولار. هذا عدا عن الثروات الطبيعية الأخرى، والقوى العاملة.
لكن في المقابل تبلغ قيمة الدين العام أكثر من 232 مليار دولار وتبلغ قيمة خدمة هذا الدين نحو 19 مليار دولار سنويًا. أي ما يعادل نحو 10 بالمئة من حصيلة صادرات السلع والخدمات.
وفي ظل مجموعة من الظروف السياسية والاقتصادية، ومع مواصلة انخفاض أداء النمو الاقتصادي في معظم البلدان العربية، ومع استخدام السياسات الاقتصادية الموالية للطبقات الثرية (وبخاصة عندما تنفذ البرامج الموصّى بها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) ومع استمرار انخفاض أسعار النفط واستمرار الظروف الإقليمية والدولية غير المواتية للنمو، في ظل ذلك كله، تزداد معدلات الفقر والبطالة (وبخاصة بين الشباب) وبالتالي تزداد نسب الحرمان من مصادر الرزق ومن الخدمات الأساسية مثل السكن والصحة والتعليم.
ونتيجة للأوضاع الأمنية في بعض المناطق ازداد عدد النازحين واللاجئين، إذ يقدر عدد اللاجئين (حسب تقديرات الإسكو عام 2015) في فلسطين 5.2 مليون وفي سورية 3.9 مليون، وفي الصومال 1.1 مليون وفي السودان 0.7 مليون وفي العراق 0.4 مليون، أما عدد النازحين فهو 7.6 مليون في سورية، و3.6 مليون في العراق، و2.2 مليون في السودان، و1.1 مليون في الصومال، و0.4 مليون في ليبيا، و0.3 مليون في اليمن. وتقدر اليونيسيف نسبة الأطفال النازحين في سورية بـ 32 بالمئة من إجمالي السكان المتضررين من الأوضاع السائدة (النازح داخل بلده واللاجئ في الخارج).
وأدت السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة المتبعة إلى زيادة مستوى عدم المساواة في توزيع الدخل والإنفاق، كما تعمّق التفاوت في توزيع الثروات وفي فرص الحصول على الحاجات الأساسية وبخاصة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.
وتشير توقعات صندوق النقد العربي لعامَي 2020-2021، في ضوء تأثيرات وباء كورونا، أن يكون لهذا الوباء تأثير سلبي عميق في الاقتصادات العربية، نظرًا إلى مساهمة القطاعات المتأثرة بالإغلاق الكلي أو الجزئي، بنحو 70 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية من ناحية، وبسبب الأضرار التي لحقت بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بنحو 45 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من جهود التنويع في النشاط الاقتصادي، فإن البلدان المصدرة للنفط لا تزال معتمدة على نحو رئيسي على قطاع النفط في اقتصادها، لذا فهي ستتأثر إلى حد كبير من الخفض العالمي في إمدادات النفط الذي قررته أوبك.
اتبعت البلدان العربية مبدأ التحفيز لمواجهة تأثيرات وباء كوفيد – 19 وبلغت حزم التحفيز (بحسب تقرير الصندوق) 232 مليار دولار، فضلًا عن إجراءات أخرى اتخذتها البلدان العربية على نحو متفاوت من بلد لآخر في مستويات تغطية شبكات الأمان الاجتماعي.
ويتوقع الصندوق نتيجة انخفاض مستويات النشاط الاقتصادي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بنسبة تقارب 4 بالمئة عام 2020، والمتوقع أن يكون تأثير الأزمة أشد على اقتصادات الدول المصدرة للنفط.
ثالثًا: هل لا يزال التكامل التنموي ممكنًا؟
لا شك في أن أسباب إخفاق محاولات التكامل بين البلدان العربية أصبحت معروفة إلى حد كبير، لدى السياسيين والمفكرين الاقتصاديين، وبالتالي فإن طريقة تجاوز السلبيات، يُفترض أنها معروفة أيضًا، كما أن سلبيات وإيجابيات تجارب التكامل الأخرى في العالم تتابع من جانب الهيئات المعنية ومن جانب الباحثين الاقتصاديين، وانطلاقًا من ذلك، ومن الوقوف على وقائع تطور الاقتصادات العربية، والعلاقات العربية، وفي ظل الواقع المأسوي في العلاقات العربية – العربية، يأتي السؤال حول إمكان تحقيق التكامل الاقتصادي – التنموي العربي؛ وبخاصة أن أي بلد عربي لا يستطيع (منفردًا) أن يواجه هاتين الأزمتين.
وإذ يبدو الموقف سوداويًا من حيث نتائجه، بسبب ما يحدث على أرض الواقع، فإن الأمل لا يزال قائمًا في إمكان تغيير الواقع، وخلق اقتراحات عملية تقتضيها مجموعة من الأسباب التي تأتي في مقدمتها مواجهة مخاطر وباء كوفيد – 19 وتداعيات الأزمة الاقتصادية، فضلًا عن الأهداف والغايات المتوخاة، من خلال تحقيق خطوات جدية على طريق التكامل.
ومن الواضح أن الوقائع التاريخية، ومنذ طرح الأهداف الطموحة للوطن العربي، تشير إلى أن بقاء البلدان العربية تحت مظلة النظام الرأسمالي الليبرالي العالمي، وربط مصير اقتصاداتها بدورة رأس المال العالمي، لن يخرجها من حالة التشرذم والتخلف، وأن أولى الخطوات الواجب اتخاذها، هي الخروج من هذه الحالة، وجعل هذه الاقتصادات تعمل لما فيه مصلحة بلدانها، وليس لما فيه مصلحة الرأسمالية المتوحشة.
وعلى هذا فإن المسألة سياسية – استراتيجية – مصيرية…
وهذا يعني الانطلاق من نقطة البداية، واستكمال عناصر التحرر الوطني، بالانعتاق من دائرة التبعية، وتركيز الجهود نحو البناء الداخلي، بعيدًا من برامج الإصلاح المعروضة من المؤسسات الدولية.
قد يبدو ذلك صعبًا في هذه المرحلة، ولكنه أيضًا غير مستحيل، فقضية التحرر الوطني قضية إنسانية وجودية، تتطلع إليها جميع شعوب العالم، والبلدان العربية ليست استثناء من ذلك.
وفي هذه «العجالة» نرى أن نقطة البداية في التكامل العربي، هي بتحويل الأزمتين إلى فرصة، تكون من لقاء دولتين أو أكثر لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والداخلية، ومواجهة آثار أزمة كوفيد – 19 ومن أجل بناء العلاقة بينها على أسس تكاملية تنموية، وبالتالي إعطاء «النموذج» الذي سيجذب إليه باقي البلدان العربية (وفقًا لظروفها) بعد أن يحقق هذا النموذج انتصارًا حقيقيًا على التخلف والجهل والفقر والبطالة، وبعد أن يلمس الجميع مدى ما يحققه من تقدم على صعيد العدالة الاجتماعية، فضلًا عن ما يحققه على الصعيد السياسي، والانعتاق من هيمنة الدول الكبرى، وبخاصة بعد ما شهده النظام العالمي من تغييرات نتيجة تراجع نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية، وصعود الصين وروسيا؛ بما يوحي بالانتقال من نظام القطب الواحد إلى نظام متعدد الأقطاب.
من هنا تبدو أهمية التكامل التنموي العربي بوصفه مطلبًا ضروريًا وممكنًا… لأنه يأتي في سياق عملية تحررية استراتيجية طموحة، خارج إطار التبعية للنظام الرأسمالي العالمي المتوحش، وخارج إطار المشروع الأمريكي الصهيوني.
المصدر : مركز دراسات الوحدة العربية.